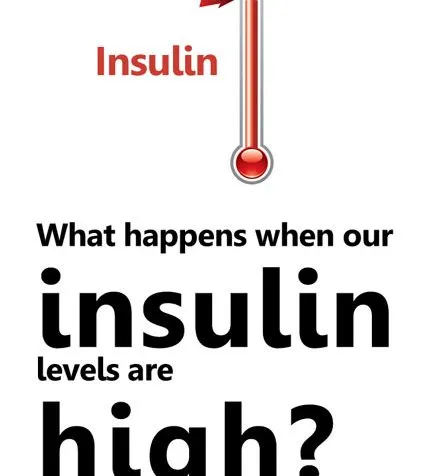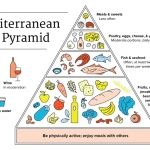- The Neuroscience of False Rewards
- The Physiology and Psychology of Compulsive Eating
- From Evolutionary Advantage to Modern Trap
المكافأة وليدة الشارها
- المكافأة وخداع الدماغ
المكافأة في علم النفس السلوكي تُعرف بأنها أي محفز يزيد من احتمالية تكرار السلوك لأن هذا السلوك يعطي شعور بالرضا او المتعة او الراحة، وتنقسم المكافآت إلى نوعين أساسيين: المكافآت الإيجابية التي تبني السلوكيات الصحية كممارسة الرياضة أو تعلم مهارة جديدة، والمكافآت السلبية التي تخدع الدماغ مؤقتاً مثل تناول السكريات للتخلص من التوتر. الطريقة الوحيدة للتمييز بينهما تكمن في النظر للنتائج طويلة المدى وليس الإحساس اللحظي. فسيولوجياً، يُحرر الدماغ هرمون الدوبامين في منطقة النواة المتكئة عند التعرض للسكر، مما يخلق إحساساً كاذباً بالإنجاز والاستحقاق. هذه الآلية تطورت لمساعدتنا على البقاء، لكنها تُستغل الآن من قِبل الصناعات الغذائية لخلق دائرة إدمان مقنعة بقناع “المكافأة المستحقة”. يُحدث السكر نفس الاستجابات في المنطقة المعروفة في الدماغ باسم ‘مركز المكافأة’ – تقنياً، النواة المتكئة – كما تفعل النيكوتين والكوكايين والهيروين والكحول. هكذا يصبح الشخص يبرر سلوكه الخاطئ بأنه “يكافئ نفسه”، بينما هو في الحقيقة يدمر صحته الأيضية تدريجياً.
- الشراهة الفسيولوجية والنفسية
الشراهة علمياً هي اضطراب في السلوك الغذائي يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في فترات قصيرة مع فقدان السيطرة على عملية الأكل. فسيولوجياً، يمكن تمييز الشخص الشره من خلال مقاومة اللبتين (هرمون الشبع) وارتفاع مستويات الجريلين (هرمون الجوع) حتى بعد تناول الطعام، بالإضافة لعدم انتظام إشارات السكر في الدم. كما يظهر لديه اضطراب في إفراز هرمونات الأمعاء مثل الـ GLP-1 والـ CCK المسؤولة عن إرسال إشارات الامتلاء للدماغ. نفسياً، الشراهة ترتبط بقوة بالحالات العاطفية السلبية كالقلق والاكتئاب والتوتر، حيث يستخدم الدماغ الطعام كآلية هروب من الألم العاطفي. السبب في ذلك أن تناول السكريات والكربوهيدرات البسيطة يؤدي لإفراز الدوبامين والسيروتونين مؤقتاً، مما يخلق وهماً بتحسن المزاج. لكن هذا التأثير المؤقت يتبعه انهيار في مستويات السكر والمزاج، مما يدفع الشخص لتكرار السلوك في حلقة مفرغة من الشراهة العاطفية التي تتنكر في صورة “راحة نفسية”.
- الإنسولين والشراهة
يتراوح مستوى الإنسولين الطبيعي في حالة الصيام ما بين 2 إلى 25 ميكرو وحدة دولية لكل مل، ولا ينبغي بعد تناول الوجبات أن يتجاوز 49 ميكرو وحدة دولية/مل. يرتفع الإنسولين بشكل أساسي عند تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة، إذ تؤدي هذه الأغذية إلى زيادة حادة في سكر الدم (الجلوكوز). في هذه الحالة، يستجيب البنكرياس بإفراز الإنسولين، الذي يُشير بدوره إلى الخلايا – لا سيما خلايا العضلات – لامتصاص الجلوكوز واستخدامه كمصدر للطاقة.
تكمن خطورة ارتفاع الإنسولين في تأثيره السلبي على إشارات الشبع في الدماغ؛ إذ يُثبّطها، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع حتى بعد تناول كمية كافية من الطعام. كما أن الارتفاع المزمن للإنسولين يُخل بتوازن الهرمونات المنظمة للشهية مثل اللبتين (هرمون الشبع) والجريلين (هرمون الجوع)، فيُصبح الدماغ غير قادر على استقبال إشارات الامتلاء ويستمر في المطالبة بالمزيد من الطعام.
تزداد المشكلة تعقيدًا عندما يؤدي الإنسولين المرتفع إلى هبوط في مستوى سكر الدم أقل من المعدلات الطبيعية، مما يدفع الدماغ إلى إرسال إشارات عاجلة تطلب تناول طعام يحتوي على الجلوكوز لإعادة التوازن. لكن ما إن يتناول الشخص طعامًا غنيًا بالسكر مرة أخرى، حتى ترتفع نسبة الجلوكوز بشكل حاد، يليها إفراز جديد وكبير للإنسولين، مما يؤدي إلى هبوط جديد في السكر… وهكذا تستمر الحلقة.
ومع مرور الوقت، ومع تكرار هذه الدورة المُرهقة، تبدأ خلايا الجسم في مقاومة الإنسولين، فلا تستجيب له بشكل فعال، مما يُجبر البنكرياس على إفراز المزيد منه لإجبار الجلوكوز على الدخول إلى الخلايا. وهنا تبدأ مقاومة الإنسولين، التي تُعدّ خطوة أولى نحو اضطرابات أيضية أكثر خطورة مثل السمنة، ودهون الكبد، والسكري من النوع الثاني.
- دائرة الخداع الفسيولوجية-النفسية
ما يحدث في الواقع ليس مجرد شهوة طعام، بل دائرة خداع دقيقة تجمع بين الفسيولوجيا وعلم النفس. فعلى المستوى البيولوجي، أظهرت التجارب أن الجرذان تفضّل الماء المحلّى على الكوكايين، بل وحتى على الهيروين، مما يوضح القوة الإدمانية الحقيقية للسكر وتأثيره العميق على مراكز المكافأة في الدماغ.
عند تناول السكريات، يحدث ارتفاع مفاجئ في الدوبامين، يُتبعه انهيار حاد، ما يُولّد رغبة ملحّة في تكرار التجربة للحصول على “الجرعة” التالية. وهنا يتدخل العامل النفسي: يربط الدماغ هذا الإحساس المؤقت بالراحة بمفاهيم مثل “الاستحقاق” و”المكافأة”، فيبدأ الشخص في تبرير استهلاك السكر على أنه فعل إيجابي بعد يوم شاق أو إنجاز معين.
الخطر الأكبر أن كل ذلك يحدث على مستوى لا واعٍ؛ فالفرد يظن أنه يتحكم في قراراته، بينما هو يُقاد فعليًا بسلسلة من الإشارات الكيميائية المختلة. تتوالى الضربات: الجسم يرسل إشارات جوع زائفة، الدماغ يفسرها كمطالبة بمكافأة، والفرد يُقنع نفسه بأنه “يستحق” قطعة الحلوى، بينما هو في الواقع يُغذّي دائرة إدمانية تغذّي نفسها، وتُضعف تحكمه الذاتي، وتدفعه نحو مقاومة الإنسولين والاضطرابات الأيضية المزمنة.
: اقتباسات من كتاب The Case Against Sugar
عندما ترتفع مستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، يفرز البنكرياس الأنسولين استجابةً لذلك، والذي بدوره يُرسل إشارة إلى خلايا العضلات لامتصاص وحرق المزيد من الجلوكوز. كما يُرسل الأنسولين إشارة إلى الخلايا الدهنية لامتصاص الدهون والاحتفاظ بها. فقط عندما يبدأ ارتفاع سكر الدم بالانحسار، تنخفض مستويات الأنسولين أيضًا، وعندها تُطلق الخلايا الدهنية وقودها المُخزن في الدورة الدموية (على شكل أحماض دهنية)؛ فتُحرق خلايا العضلات والأعضاء هذه الدهون بدلًا من الجلوكوز. يُضبط سكر الدم ضمن نطاق صحي، وتتدفق الدهون داخل الخلايا الدهنية وخارجها حسب الحاجة. العامل البيولوجي الوحيد الضروري لإخراج الدهون من الخلايا الدهنية واستخدامها كوقود، كما أشار يالو وبيرسون عام ١٩٦٥، هو “الحافز السلبي لنقص الأنسولين”. دفعت هذه الاكتشافات حول مختلف وظائف الأنسولين يالو وبيرسون إلى وصفه بأنه الهرمون الأكثر “تكوينًا للدهون”، أي مُكوّنًا للدهون. ويجب خفض هذه الإشارة، أو كتمها بشكل ملحوظ، حتى تُطلق الخلايا الدهنية دهونها المُخزنة، وليستخدمها الجسم كوقود.
تجد الجرذان التي تُعطى ماءً مُحلّىً في التجارب أن ذلك أكثر متعة بكثير من الكوكايين، حتى عندما تكون مدمنة على الأخير، وأكثر من الهيروين أيضاً (على الرغم من أن الجرذان تجد هذا الاختيار أصعب في اتخاذه).
لم يكن هناك أي غموض يُذكر حول استهلاك السكر. «نتناول الآن خلال أسبوعين كمية السكر التي كان أجدادنا يتناولونها قبل 200 عام في عام كامل»، كما كتب خبير التغذية بجامعة لندن، جون يودكين، عام 1963، عن الوضع في إنجلترا. «يوفر السكر حوالي 20% من إجمالي استهلاكنا من السعرات الحرارية، وما يقرب من نصف استهلاكنا من الكربوهيدرات».
لذا، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه كمعلمة هو: إذا أخبرتُ الناس أنني أعتقد أنهم يتناولون الكثير من السكر، وإذا أخبرتُ الأمهات أنني أعتقد أن عليهن منع أطفالهن من تناول الكثير من السكر لأنه ضارٌّ بصحتهم، فهل سأتعرض لانتقادات العلماء؟ أم سيُسمح لي بالإدلاء بهذا التصريح دون عناء، على أساس أنه على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة تربط السكر بمرضٍ محدد، فإننا نعلم أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية أقل بكثير من السكر، والذي يُستبدل فيه السكر بكربوهيدرات معقدة، سيكون نظامًا غذائيًا صحيًا أكثر؟ جوان جوسو، رئيسة قسم التغذية بجامعة كولومبيا، 1975 ―
في نهاية المطاف وبشكل واضح، تصبح مسألة تحديد ‘الكمّ المفرط’ قراراً شخصياً، تماماً كما نقرر جميعاً كبالغين أي مستوى من الكحول أو الكافيين أو السجائر سنتناوله. لقد جادلتُ هنا بأن هناك أدلة كافية لكي نعتبر السكر مادة شديدة السمية على الأرجح، ولنتخذ قراراً مستنيراً حول أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين المخاطر المحتملة والفوائد.
ولكن، لمعرفة ما هي تلك الفوائد، من المفيد أن نرى كيف تبدو الحياة بدون سكر. سيخبرك المدخنون السابقون (وأنا أحدهم) أنه كان من المستحيل عليهم استيعاب، فكرياً أو عاطفياً، كيف ستكون الحياة بدون سجائر حتى أقلعوا؛ وأن الأمر كان صراعاً مستمراً على مدى أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. ثم، في أحد الأيام، وصلوا إلى نقطة لم يتمكنوا فيها من تخيل تدخين سيجارة، ولم يتمكنوا من تخيل لماذا دخنوا من الأساس، ناهيك عن اعتبار الأمر مرغوباً. من المرجح أن تكون تجربة مماثلة صحيحة بالنسبة للسكر – ولكن حتى نحاول العيش بدونه، وحتى نحاول الحفاظ على هذا الجهد لأكثر من أيام، أو بضعة أسابيع فقط، فلن نعرف أبداً.
تطور الشراها
- من اللغة إلى السلوك
الشراهة، في أصلها اللغوي، مشتقة من الفعل “شَرِه” والذي يعني الطمع أو الإفراط في الرغبة. هذا المصطلح يُستخدم في وصف سلوك الإنسان عند تناوله الطعام بشكل مفرط، لكنه في الحقيقة يُعبّر عن ظاهرة نفسية وسلوكية أعمق تتجاوز حدود الأكل، لتلامس البنية الغريزية للإنسان.
علماء النفس والفلاسفة تعاملوا مع مفهوم الشراهة كصراع داخلي بين قوى متناقضة: العقل والهوى، أو ما يُعرف علميًا بـ”التحكم التنفيذي” في قشرة الفص الجبهي مقابل “نظام المكافأة” في الدماغ الأوسط. هذا التوتر الداخلي هو ما يدفع الإنسان أحيانًا للتصرف ضد مصلحته الطويلة الأمد، لصالح إشباع لحظي سريع.
- الشراهة في التراث الفلسفي والديني
في الفلسفة اليونانية، ناقش أرسطو مفهوماً قريباً من الشراهة ضمن فضيلة “الاعتدال”، حيث اعتبر الإفراط في أي لذة (مثل الأكل) علامة على انعدام التوازن في الشخصية. هذا يتطابق مع طرح الفيلسوف المسلم أبو حامد الغزالي، الذي صنّف الشراهة كواحدة من “آفات النفس” التي تحجب الإنسان عن سموّه الروحي.
كلا المدرستين تتفقان على أن الإفراط في اللذة ناتج عن ضعف في الضبط الذاتي، وتعتبر الشراهة انحرافًا في العلاقة الطبيعية بين الإنسان وحاجاته الأساسية.
- التفسير البيولوجي للشراهة: منظور تطوري
من منظور علم الأحياء التطوري، يمكن فهم الشراهة كسلوك نشأ في ظروف بيئية كان فيها الغذاء نادراً. أسلافنا الذين كانوا يستهلكون أكبر قدر ممكن من الطعام عند توفره، كانوا يملكون فرصة أكبر للبقاء أثناء فترات المجاعة.
هذا ما يُعرف بـ”فرضية الجين الموفر للطاقة” (Thrifty Gene Hypothesis)، والتي تفسر ميل الإنسان الحديث لتخزين الدهون والإفراط في الأكل حتى بعد زوال خطر الجوع. لكن هذا السلوك الذي كان مفيدًا في الماضي، أصبح اليوم ضارًا في بيئة تتميز بالوفرة الغذائية وسهولة الوصول إلى الطعام عالي السعرات ومنخفض القيمة الغذائية.
- الأنسولين والشراهة: تفسير فيسيولوجي
من منظور أصولي، الإنسان كائن لم يُخلق في بيئة وفرة مستمرة، بل في واقع يتسم بالتفاوت، بالتوتر بين الندرة والوفرة، وبين الحاجة والمفاجأة. في هذا السياق، لم يكن “الحلو” أو “الدهني” مكافأة دورية أو عادة مكررة، بل حدث نادر، أشبه بـ”اللقطة” البيئية التي تتطلب استغلالًا لحظيًا. لذلك، تشكلت لدى الإنسان القديم استجابة فطرية لمثل هذه اللحظات، وهي: أن يأكل فورًا، وبشراهة، عندما تتاح الفرصة.
الجسم استوعب هذه الفكرة في نظامه البيولوجي. الأنسولين، كرسول حكمة داخلية، لم يكن فقط منظمًا للسكر، بل حارسًا لإيقاع الشهية. كان دوره حماية الإنسان من الإفراط، أو تحفيزه عند الحاجة. لكنه اليوم لم يعد يعمل في نفس السياق الأصلي.
في عالم الوفرة الحديثة، وخاصة مع توفر السكريات والنشويات المكررة، اختلت المعادلة. لم تعد تلك الأطعمة تظهر كمفاجأة، بل أصبحت عادة. هنا، يبدأ الأنسولين في التمرد. الإفراط المزمن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ويجعل الجسم غير قادر على قراءة إشارات الشبع بشكل صحيح. النتيجة: تضخُّم في الرغبة، وانكماش في الإشباع.
لكن الأسوأ من ذلك هو انقلاب المفهوم: أصبح الإنسان يعتبر تلك الأطعمة “مكافأة”، بينما في أصل تكوينه لم تكن كذلك. العقل البشري، خصوصًا تحت تأثير الدوبامين، يترجم السكر والدهون إلى لحظة بهجة، لكنه ينسى أنها ليست إلا إشارة مضللة في سياقٍ مشوَّه.
بهذا المعنى، الشراهة ليست فشلًا إراديًا، بل فقدان للبوصلة الوجودية التي كانت تفهم متى يكون الأكل بقاءً، ومتى يتحول إلى عبء. الجوع لم يعد حقيقيًا، بل أصبح اصطناعيًا – يغذيه نظام عصبي مشوش، ونمط حياة منفصل عن حكمة الأصل.
التحول الحضاري: من الحاجة إلى الإدمان السلوكي
في الماضي، كان الطعام مرتبطًا بالبقاء، أما الآن فقد أصبح وسيلة للترفيه وتسكين القلق والتوتر. عالم الاجتماع الفرنسي “جان بودريار” تحدث عن مجتمع الاستهلاك الذي يُعيد تشكيل الحاجات الإنسانية في صورة رمزية، بحيث تصبح الأطعمة الفاخرة أو الحلويات تعبيراً عن المكانة الاجتماعية أو الهوية.
وهكذا لم يعد الأكل يستجيب فقط لحاجة بيولوجية، بل أصبح أداة للهروب من الضغوط، وعلاجاً مؤقتاً للمشاعر السلبية. وعلامة من علامات الرقي والغني.
- الشراهة كخلل في الحوار الداخلي للجسم
عندما تُفرَض على الجسم إشارات خارجية متكررة (مثل الإعلان عن الطعام، والسكر الزائد)، تبدأ أنظمة الشبع الطبيعية في التراجع. يشبه الأمر نظاماً برمجياً يتلقى إشارات خاطئة باستمرار، فيفقد قدرته على تمييز “ما يحتاجه” من “ما يُفرض عليه”.
هنا، الشراهة لا تكون ضعف إرادة، بل خللاً في نظام الاستشعار الداخلي للجسم والعقل. يُصاب الإنسان بـ”الجوع العاطفي” أو “الجوع الوجودي”، وهو شعور دائم بالنقص رغم الامتلاء الجسدي. او من جهة اخري تزرع هذه الإعلانات رسالة بمدي فائدة هذه الأنواع من الاكل كانوع من المكفاءة مثل اروي عطشك بشرب كوكولا
- الاستنتاج: حين تتحول المكافأة إلى شراهة
في أصل تكوينه، لم يعرف الإنسان مفهوم “المكافأة الغذائية” كما نعيشه اليوم. لم يكن يعثر على التمر أو العسل أو الدهون بشكل يومي ليكافئ بها نفسه بعد مجهود، بل كانت تظهر فجأة، كحدث نادر، أقرب إلى المفاجأة منها إلى الاستحقاق. وكانت الاستجابة الفطرية حينها واضحة: أن يغتنمها، لا أن يطالب بها بشكل منتظم.
لكن في عالمنا المعاصر، دخل الإنسان في وهم جديد: أن كل ما يشتهيه هو “حق”، وأن السكر بعد التعب، أو الوجبة الدسمة بعد إنجاز، ليست رغبة بل استحقاق. هذه الفكرة رسّخها الدماغ حين صار يُترجم المكافأة إلى تكرار، والمتعة العابرة إلى عادة.
ما يحدث فعليًا هو أن المخ يُخدع. يعيد تفعيل دوائر المكافأة، لا استنادًا إلى المفاجأة، بل بناءً على توقّع مصطنع ومتكرر. وبذلك، تتحول المكافأة إلى إدمان ناعم، وتتحول الحاجة العرضية إلى شراهة مستمرة.
من هنا، فإن “ضبط العلاقة بين الإنسان واحتياجاته” لا يعني فقط تقنين الطعام، بل استعادة المعنى الأصلي للمكافأة، وفهم أن السعادة لم تكن يومًا في التكرار، بل في التقدير والندرة. وأن العودة إلى الفطرة، هي السبيل الوحيد للخروج من وهم الإشباع المستمر.